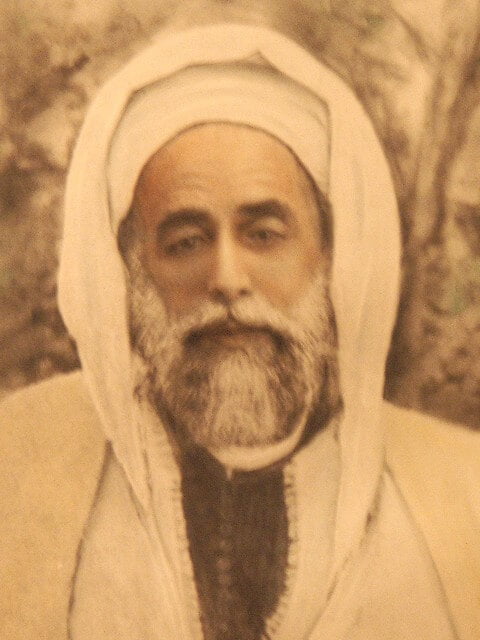بســم الله الرحمن الرحيــم
صناعة الكتابة
قال رضي الله عنه :”أما صناعة الكتابة فلم نتعاطاها، ولا دخلت الكتاب ولو يوماً واحداً، إلا ما استفدته من أبي رحمة الله عليه، عندما كان يُلقي علي بعض لدروس قرآنية بدارنا، وإلى الآن لم نحصل على القدر الكافي منها، وانتهى بي الحفظ في كتاب الله إلى سورة (الرحمن)، فبقي اللوح على تلك السورة، بما اشتغلت به في ذلك الحين من تعاطي بعض الأسباب التي دعتني إليها الضرورة، بما أن العائلة أعوزها ما كان بيديها، وكان الأب رحمة الله عليه رفيع الهمة، متعففا للغاية، لا يُبدي صفحات وجهه لأي أحد كان، بحيث أنه لا يظهر عليه سمة الإحتياج البتة، فترددت بين عدة مهن، و في الآخر لازمت صناعة الخرازة، فمهرت فيها وتوسع الحال من أجلها، فبقيت عليها سنوات إلى أن انتقلت إلى التجارة، و كنت فقدت الأب على رأس السنة السابعة عشر من سني، فذهب إلى عفو الله وهو عني راضٍ، وكنت مع صغر سني أستعمل معه سائر أنواع البُرور، ولا غاية نُحاولها أكثر من إدخال السُّرور عليه، وكان يُحبني حبّاً مفرطاً، ولم نعقل عنه أنه نهرني أو ضربني إلا في أوقات تعليمه إياي، كان ذلك منه بما أني كنت متراخيا في القراءة. أما الوالدة رحمها الله فكانت أشد من الوالد تفنُّنا في محبتي، وأقوى تحفظاً على سلامتي، حتى كانت تمنعني ليلاً من الخروج بما أمكنها من نحو الشتم والضرب و غلب الباب و غير ذلك، لكن بعد وفاة الأب وكم كنت أحاول إسعافها، ولكني لم أتوقف عما كنت أحافظ عليه من ملازمة بعض الدروس ليلاً، وبعض اجتماعات للذكر، وكان ذلك منها بمناسبة سكنانا خارج البلد، و الطريق مخوف والمشي بالليل على المنفرد متعذر، وهكذا دامت رحمة الله عليها على منعها إياي ودمت أنا على حضور تلك المجالس، إلى أن من الله علينا برضاها الأوفى، فصفت المودة بيني وبينها، ودامت على ذلك إلى أن انتقلت إلى رحمة الله عام 1332هـ – 1914م، وأنا على سن الستة والأربعين سنة، وكنت في جميع تلك المدة على أتم محافظة من جهة برها، والحمد لله، والله ولي التوفيق.
ملازمتي للدروس
أما ملازمتي للدروس فلم تكن ملازمة تُعتبر بما أنها كانت تقع خلال أوقات الإشتغال وأوقات متفرقة، ولولا القريحة وملكة الفهم، ما كنت أتحصل منها على شيء يُذكر، غير أني كنت نديم المُطالعة، وقد نستغرق الليل بتمامه، وكان يُعينني على ذلك بعض المشايخ كنت أصحبه لمنزلي، ودمنا على ذلك مدة شُهور حتى تضرر بذلك بعض الزوجات، وطلقن علينا بدعوى عدم القيام بحقوقهن، وقد كان شيء من ذلك، وكيفما كانت الملازمة للدروس فإنها لم تبلغ حد السنتين، ولكني مارست فيها بعض فنون زيادة على ما اكتسبته من ملكة الفهم، ولكن ما تفتق ذهننا وتوسعت معلوماتنا حتى اشتغلنا بعلوم القوم، وصحبتنا لرجال الفن.
سبب الإشتغال بهذا الفن
فقلت له لا بأس لو أطلعتمونا على سبب الإشتغال بهذا الفن، وماهو أول قدم كان لكم في صحبة أهل الطريق؟
فقال : أول ميل كان وقع لي لأهل النسبة على الإجمال، تعلقي بأحد الرجال من السادات العيساوية، كنت أراه متعففا يظهر عليه أثر الصلاح، وبعد ذلك اشتغلت بما تقتضيه تلك النسبة اشتغالاً كُلياً، وأعانني على ذلك حالة الصِّبا، وما عليه الطبع الفطري من جهة ميله للخوارق، وقد مهرت في ذلك وكانت لي حظوة بين رجال تلك النسبة، وكانت عقيدتي فيما أتعاطاه إلا التقرب إلى الله عز وجل جهلاً منّي، ولما أراد الله أن يُلهمني، كنا ذات يوم ببعض اجتماعاتنا فرفعت نظري إلى ورقة كانت في حائط ذلك المنزل، فوقع بصري اتفاقاً على كلام ينسبه صاحبه حديثاً، فاستفدت منه ما ألزمني بترك ما كنت أتعاطاه من الخوارق، وألزمت نفسي على أن أقتصر في تلك النسبة على ملا كان من قبل الأوراد والأدعية والأحزاب، ومن ذلك الحين أخذت أتنصل وأعتزل للجماعة، إلى أن تركت جميع ذلك، وكنت أُريد أن أزحزح الجماعة بتمامها، ولكنه لم يتيسر. أما أنا فتنصلت كما كانت نيتي، ولم يبق لي من ذلك إلا أخذ الحية، فقد استمريت على أخذها بانفرادي، أو مع بعض الأحباب، إلى أن اجتمعت بالأستاذ الشيخ سيدي “محمد البوزيدي” رضوان الله عليه. فقال لي ذات يوم وهو عندنا بدكاننا : إنه بلغني أنك تأخذ الحية ولا تخشى من لسعها. فقلتُ له : نعم، كذلك كنت. فقال لي : هل يمكنك الآن أن تأتينا بواحدة فتأخذها بحصورنا؟ فقلت له : مُتيسر. وذهبت من حيني إلى خارج البلد، وبعد ما مر علي نصف يوم لم أجد إلا واحدة صغيرة يقرب طولها من نصف ذراع، فجئت بها ثم وضعتها بين يديه، وأخذت أقلب فيها كما هي عادتي، وهو ينظر رضي الله عنه إلى ذلك، ثم قال لي : هل تستطيع أن تأخذ أكبر من هذه الحية مما هو أكبر منها جرما؟ فقلت له : إنها عندي على السواء، فقال لي : ها أنا أدلك على واحدة أكبر وأشد منها بأساً، فإن أمسكتها وتصرفت فيها فأنت الحكيم. فقلت له : فأين هي؟ فقال : نفسك التي بين جنبيك، فإن سمها أشد من سم الحية، فإن أمسكتها وتصرفت فيها فأنت الحكيم. ثم قال لي : اذهب وافعل بهاته الحية ما هو عادتك أن تفعل بها ولا تعُد لمثل ذلك. فخرجت من عنده، وأنا أتخيل في شأن النفس وكيف يكون سمها أشد بأساً من سم الحية.
اجتماعي بالأستاذ
وأما اجتماعي بالأستاذ المذكور رضوان الله عليه وأمدنا الله من فيوضات أسراره، فإني كيفما تأملته إلا وأجده محض توفيق من الله عز وجل، فإننا ما سافرنا إليه ولا قصدناه لمحله، بل هو الذي زارنا لمحلنا على حين غفلة. كنت أتذاكر مع شريك لي في التجارة وهو الأخ المرحوم المقدم سيدي “الحاج بن عودة بن سليمان” ونتفاوض دائماً في شأن الصالحين وأحوال العارفين، ونرى من الواجب المتحتم اتخاذ قدوة في طريق الله على الشرط المقرر بين أهل الفن، ولكن كنا نستبعد الحصول على من هو بتلك الصفة المقررة، وعلى كل حال فقد كنا بصدد البحث، إلى أن وفق الله ذات يوم رفيقي فقال لي : كنت أعرف أحد المشايخ يدعى “حمو الشيخ” شريف النسب، كان مهاجراً بناحية المغرب سنين، وعندما تعلقت به جماعة، وقد كان تكلم في طريق القوم غير أنه سلط الله عليه من يُؤذيه، وتوجهت عليه الإعتراضات. أما الآن فهو كأحد الطلبة خاملاً لا يُرى عليه شيء من ذلك، وفي ظني أنه يكون ذلك الرجل ممن يُعتمد عليه في طريق الله، حسبما دلت عليه سُنة الله في خلقه، ما من مرشد ظهر إلا سلط الله عليه من يُؤذيه، إما من بين يديه أو من خلفه. قال لي كلاماً هذا معناه، وعند ذلك عقدنا العزيمة على الإجتماع به اعتماداً على ما ذكره رفيقي، أما أنا فما كنت أعرفه سوى يوم سمعت باسمه في حال الصغر بمناسبة مرض كان أصابني فجيء إلي برُقية، فقيل لي : هذا من عند سيدي “حمو الشيخ البوزيدي”، فاستعملتها فعوفيت من ذلك. ثم إنا ونحن من بعد أيام في تجارتنا وإذا برفيقي يقول لي : هذا هو الشيخ ماراً على الطريق. ثم قام إليه، ودعاه إلى الجلوس عندنا فجلس، ثم دار الكلام بيننا، ولم أدر في أي موضوع كان الحديث بما كنت مشتغلاً به من الأسباب، ولما أراد الخروج رضي الله عنه طلب منه رفيقي أن لا يقطع زيارتنا، ثم ودعناه وانصرف، وبعد ذهابه سألت رفيقي عما وجده من حديثه، فقال : إن كلامه أعلى مما في الكتب. وهكذا كان يزورنا في تلك المدة وكان رفيقي هو الذي يُباشره بالسؤال والتحدث بكثرة، أما أنا فكانت تمنعني هيبته تارة والإشتغال بالتجارة أخرى، وفي خلال تلك المدة أخذ ذات يوم يُحقق فيّ، ثم قال للمقدم الذكور : “إن الولد صالح للتربية” أو قال :”فيه قابلية للتربية”، وفي مرة وجد بيدي ورقة فيها ما يتعلق بمدح الشيخ سيدي “محمد بن عيسى” رضي الله عنه، وبعدما نظرها قال لي : إذا طالت بنا الحياة تكون إن شاء الله من أشباه الشيخ محمد بن عيسى أو تكون في مقامه. فاستبعدت ذلك من نفسي, غير أني قلت له : إن شاء الله. وبالجملة لم تمر علي مدة حتى تعلقت به واتخذته قدوة في طريق الله، وكان رفيقي تقدم علي في ذلك بنحو الشهرين خفية مني، وما أخبرني إلا بعد تعلقي أنا، ولست أدري ما هي نيته في ذلك، وبعد أن لقنني الأوراد صباحاً ومساءً أوصاني ألا أتحدث بذلك، وقال لي :حتى نُخبرك. فلم يمرَّ علينا نحو الأسبوع حتى دعاني وأخذ يتكلم معي في الإسم الأعظم وفي كيفية الإشتغال به، ثم أمرني بالإنقطاع للذكر على الكيفية المقررة في ذلك الوقت، ولم تكن له رضي الله عنه خلوة مخصوصة للذكر، ومن أجل ذلك لم أتوفق لمحل صالح للإنفراد، فاشتكيت له ذلك، فقال لي : لا محل أصلح للإنفراد من المقبرة. فانفردت بها ليلاً فلم يتأتَّ لي ذلك، ولم تجتمع همتي على الذكر، مع أني حاولت ذلك أياماً، كل ذلك لما كان يعتريني من الرعب، فاشتكيت إلى الشيخ، فقال لي : أنا ما أمرتك بذلك على سبيل اللزوم، إنما قلت لا محل أصلح للإنفراد من المقبرة. ثم أمرني أن أقتصر في الذكر على ثلث الليل الأخير، وخكذا كنت أذكر ليلاً وأجتمع به نهاراً، إما بمجيئه عندي أو بذهابي عنده، غير أن المحل عنده لم يكن قابلاً للإجتماع دائماً من جهة العيال وغير ذلك. وكنت مع ذلك ألازم بعض دروس علمية كانت لي من قبل، أحضرها وسط النهار. فسألني ذات يوم : بأي فن يتعلق هذا الدرس الذي أراك تُحافظ عليه؟ فقلت له بفن التوحيد. وأنا الآن في تحقيق البراهين. فقال : قد كان سيدي فلان يُسميه بفن التوحيل. ثم قال : إن الأولى لك الآن أن تشتغل بتصفية باطنك حتى تُشرق فيه أنوار ربك، فتعرف معنى التوحيد، أما علم الكلام فلا تستفيد منه إلا زيادة الشكوك وتراكم الأوهام. قال لي كلاماً هذا معناه. ثم قال لي : الأولى لك الآن أن تترك سائر الدروس حتى تفرُغ من عملك الحاضر، لأن تقديم الأهم واجب. وإنه لم يشق علي شيء من أوامره مثلما شق علي هذا الأمر حتى كدت ألا أمتثله بما تعودته من محبة الدروس مع مساعدة الفهم، لولا أن ألقى الله بباطني : وما يُدريك أن يكون ذلك من قبيل العلم الذي أنت طالبه أو أعلى منه. وثانيا سليت نفسي بما أنه لم يكن المنع مؤبداً، وثالثاً بما أني كنت بايعته على الإمتثال، ورابعا قلت أنه ربما أراد أن يمتحنني بذلك كما هي عادة المشايخ، وكل ذلك لم يفدني سلامة من وقوع حزازة في الباطن، إلا أنها ذهبت بما أني استبدلت أوقات القراءة بالإنفراد للذكر وبالأخص عندما بدأت تظهر لي نتائج الذكر.
السير الغالب الذي كان يعتمده
أما كيفية تدريجه للمريد رضي الله عنه فقد كانت تختلف، فمنهم من يتكلم معه في صورة آدم، ومنهم من كان يتكلم معه في صفات المعاني، ومنهم من كان يتكلم معه في الأفعال الإلهية، وكل كلام بكيفية تخصه.
أما السير الغالب الذي كان يعتمده، واعتمدناه نحن من بعده أيضاً، فهو أن يُكلف المريد بذكر الإسم المُفرد مع تشخيص حُروفه، حتى ترتسم –أعني الروف- في مُخيلته، ثم يأمره ببسطها وتعظيمها إلى أن تملأ الحروف مابين الخافقين، ويُديم الذكر على تلك الهيئة إلى أن تنقلب صفاتها إلى شبه النور، ثم يُشير له بالخروج عن هذا المظهر بكيفية يتعذر التصريح بها، فينتهي روح المُريد بسرعة مع تلك الإشارة إلى خارج الكون مالم يكن المريد قليل الإستعداد، وإلا احتيج إلى تصفية وترويض، وعند تلك الإشارة يقع للمريد التمييز بين الإطلاق والتقييد، ويظهر له هذا الوجود مثل الكرة أو القنديل، معلقاً في فراغ معدوم البداية والنهاية، ثم يصير يضعف في نظلره مع ملازمة الذكر، ومصافبة الفكر، إلى أن يصير أثراً بعد عين، ثم يصير لا أثر ولا عين، ويبقى على تلك الحالة حتى يستغرق المريد في عالم الإطلاق، ويتمكن يقينه من ذلك النور المجرد، والشيخ في كل ذلك يتعاهده ويسأله عن أحواله، ويُقويه على الذكر حسب المراتب، حتى ينتهي إلى غاية يشعر بها المريد من نفسه ولا يكتفي منه إلا بذلك. وكان رضي الله عنه دائماً يتلو قوله تعالى : (ويتلوه شاهد منه)، فإذا تمت غاية المريد في هذا المشهد حسب المشارب من قوة وضعف، فيرجع به إلى عالم الشهادة، بعد الخروج عنه، فينقلب في نظره على خلاف ما كان عليه، وما ذلك إلا لإشراق بصيرته، وكيفما كان لا يراه إلا نوراً على نور، وكذلك كان من قبل. وفي هذا المقام قد يختلط على المريد الحابل بالنابل، فيقول كما قال غير واحد :”أنا من أهوى ومن أهوى أنا”، وما هو من هذا القبيل فيرجمه من لا خبرة له بمحصولات القوم وشطحاتهم بما شاء أن يرجمه به. ولكن لا يبعد صاحب هذا المقام أن يتلوه التمييز بين المشاهد، فيصير يُعطي المراتب حقها، ويُوفي المقامات قسطها، وقد كان أخذني هذا المقام واستوطنت به سنوات، فتفننت فيه، ونوهت بمقتضياته، فتناول الأتباع ما كتبناه في ذلك في كوني تحت حال سُطوته، فمنهم من هو الآن على علم بمُقتضياته، ومنهم من هو دون ذلك. وهكذا لا يزال يعدوني أحياناً، ولكنه لم يقض علي بالكتابة فيه. نعم يدعوني إلى كلام لكنه أيسر مؤونة، وأقرب إلى الشعور منه إلى الإستغراق. ثم أقول أن المسلك الأخير الذي ذكرناه عن أستاذنا رضي الله عنه، هو الذي اعتمدناه في طريقنا، وسيرنا عليه أكثر أتباعنا، بما أنّا وجدناه أقرب المسالك في طريق السيرإلى الله، هذا وبعدما استنتجت ثمرة الذكر التي هي المعرفة بالله على طريق المشاهدة، ظهر لي تقصيري فيما كنت عليه من جهة معلوماتي في فن التوحيد، وذقت حينئذ ماكان يشير إليه الأستاذ، وبعد ذلك أمرني أن أشتغل بحضور الدروس التي كنت أحضرها قبل، ولما أخذت في حضورها وجدت نفسي على غير ما كنت عليه من الفهم، وصرت أتلقف المسألة قبل أن يُتم الشيخ تصويرها، ثم أستنتج فهما زائداً على ما يعطيه ظاهر اللفظ، وبالجملة إني وجدت فهماً لا مناسبة بينه وبين ما كنت عليه من قبل، وهكذا أخذت تتوسع عندي دائرة الفهم، حتى كنت إذا قرأ القارئ شيئاً من كتاب الله تسبق مشاعري إلى حل معانيه بأغرب كيفية في زمن التلاوة، ولما تمكن ذلك مني، وتحكَّم تحكُّم الطبيعيات، خشيت أن أدخل تحت تصرف ذلك الوارد الملازم، فأخذت في كتابة ما يُمليه الضمير في كتاب الله، فأُخرجه في صبغة ليست مألوفة، بما أني كنت تحت تصرف ذلك الوارد، وهذا هو الذي حملني في البدإ على (شرح المرشد المعين بطريق الإشارة)، تحاشياً مني أن أقع فيما هو أبلغ عبارة. فكان ذلك والحمد لله سبباً في رد هجومات ذلك *** ص8 الذي حاولت إيقافه بكل معنى، وما استطعت، وعند ذلك وقف الفهم مني فيما يقرب من الإعتدال، وقد كان وقع لي مثل ذلك أيضاً قبل أن أجمع الكتاب المُسمى (بمفتاح الشهود في مظاهر الوجود)، الذي هو في الهيأة، تعلقت همتي بالعلويات لأسباب، وطاش سهم الفكر والحديث يطول. وقد نبهنا على شيء من ذلك في الكتاب نفسه، وبما أني كنت لا أستطيع دفع ذلك التيار، اشتكيت إلى الأستاذ رضي الله عنه فقال لي : “انزعه من دماغك، وضعه في كتاب فإنك تستريح من ذلك”. فكان الأمر كما ذكر، والكتاب إلى الآن
لم تسمح نفسي بنشره، والله يعلم بما في المستقبل.
ينبغي لك الآن أن تحدث وترشد الناس
ثم أعود لما كنت بصدده فأقول : ولما فرغت من الإشتغال بالإسم الذي كنت كلفته على سبيل اللزوم، وما كان ذلك إلا بعد أيام طوال، قال رضي الله عنه : “ينبغي لك الآن أن تحدث وترشد الناس إلى هذه الطريق، حيث إنك على يقين من أمرك”. فقلت له : “وهل ترى أنهم يسمعون لي؟” فقال : “إنك تكون مثل الأسد، مهما وضعت يدك على شيء إلا أخذته”. فكان الأمر كما ذكر، وكنت مهما تكلمت مع أحد وعقدت العزيمة على انقياده للطريق إلا وانقاد لكلامي، وعمل بإشارتي، حتى انتشرت تلك النسبة والحمد لله. وقد كنت سألته مرة عن أمره إياي بالتحدث، بعد أن كان أمرني بالسكوت أولاً. فقال لي :”كنت عندما قدمت من المغرب تكلمت بهذا الفن كما كنت قد تكلمت به من قبل، ولما واجهني الوجود بالإعتراض، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسكوت، ومن ذلك العهد وأنا ساكت حتى كدت أن أحترق، وقبل اجتماعي بكم رأيت كأن جمعاً من الفقراء وما من واحد منهم إلا وسُبحتي في عنقه ولما أفقت استفدت من الرؤيا ما يُشعر بحركة في المستقبل، ولهذا قبلت منكم نشر الدعوة، وإلا لما تجاسرت أن آذن لكم في الإعلان، وفي هذه الأيام الأخيرة رأيت من يقول لي : تحدث ولا حرج”. ولعله كان يعني بالقائل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم. وهذا ما كان من أمر بدايتنا، ثم دمنا على صحبته خمسة عشر من السنين، عاملين في كل ذلك على نصرة الطريق، وقد وازرني على ذلك عدة رجال، فما بقي من كبارهم إلا ما يقرب من العشرة أمدّ الله في حياتهم وزاد في عنايتهم، آمين. أما أنا فقد كنت في طريق تلك المدة متفانياً في خدمة الشيخ، وعاملاً على بث الطريق، حتى كنت أهمل بعض الضروريات من الأشغال، ولولا صحبة المقدم ولي الله سيدي “الحاج بن عودة بن سليمان” الذي كان يحافظ لي على ماليتي، ويضبطني من جهة تجارتي، لقضيت عليها من أصلها، وبما كنا عليه من التفنن في خدمة الطريق، حتى كاد يظهر محل تجارتنا بصفة زاوية، أكثر من أنه كان به التدريس ليلاً، والذكر به نهاراً، وكل ذلك لم ينقص والحمد لله من ماليتنا، ولا قضى بتقصير في تجارتنا.
قبل وفاة الأستاذ رضي الله
ثم أنه قبل وفاة الأستاذ رضي الله عنه ألقى الله في قلبي حب الهجرة فأخذت أتسبب في الإنتقال إلى جهة المشرق بكل وسيلة، بما كنت أرى عليه الوطن من فساد الأخلاق، وكانت جماعة من أصدقائي على هذه النية، ومع أني كنت على علم من أن الأستاذ لا يسمح لي بمفارقة الوطن إلا إذا كان مُصاحبا لنا، ولكن حملتني إلى ذلك دواعي متعددة، وبعد ما شرعت في سبب الإنتقال، وباشرت الأعمال، وكان ذلك قبل وفاته بأيام، وقد تجردت من جميع الشواغل، وبعت ما بكسبي، ورهنت ما تعذر بيعه من العقار بقصد أن يتكلف الغير ببيعه بعد الذهاب، وقد كان سبقني في السفر أبناء عمي، وعندما كنت على وشك السفر إذ الأستاذ رضي الله عنه اشتد به المرض، وظهرت عليه بشائر الرحيل، فلم تسمح نفسي بمفارقته وهو على تلك الحالة، وهكذا لم يسمح أصدقائي بذلك، وكان الأستاذ رضي الله عنه في ذلك المرض معقود اللسان عن النطق مع سلامة الفهم.
انتقال الأستاذ
أما أنا فالأمر الذي كان يؤلمني بكثرة هو ما تشعب علي من الأعمال التي يتعذر تطبيقها، منها ما كان عليه الأستاذ من المرض الذي يستلزم المكث معه، ويُباينه ما كان بيدنا من رخصة السفر مع الأهل، وكان الأجل المضروب لها على انقضاء، وإذا تم ذلك فلا تُسخر من بعد، ويكون الضرر أشد، بما أن الرخصة يتعذر صدورها في ذلك الحين، ولما كنت عليه أيضاً من تعطيل الأسباب وبيع الأثاث، وبالجملة فكأني كنت في بلد غير بلدي، وقبل ذلك كنت بعثت الزوجة إلى أهلها بمدينة تلمسان لتُوادعهم، وكيفما كان الحال، اخترت أن أترك الأستاذ على آخر نفس وأذهب بعدما قضيت معه خمس عشرة سنة أُحافظ على بره، وما كنت عققته بشيء ولو قل، ولم تمر أيام قلائل حتى انتقل الأستاذ إلى رحمة الله، ولم يخلف عقبه لا إبنا إلى الجذب أقرب منه إلى الشعور، يُدعى سيدي مصطفى، وهكذا خلف زوجة وأخوين أحدهما السيد الحاج أحمد وهذا الآن متوفي، والآخر يدعى السيد عبدالقادر ولم يزل في قيد الحياة.
أما الشيخ رضي الله عنه فقد كان يُحب أهله محبة فارطة، ولاأخص ابنه سيدي مصطفى المذكور، وقفد رأيته رضي الله عنه عند وفاته يمد البصر إلى ابنه بما يعلمه من جذبه، وكان يخشى أن يُهمل بعده، ولما علمت ذلك منه قلت له :”اكفنا أنت يا سيدي ما أهمنا من جهة الله تعالى، ونحن نكفيك من جهة سيدي مصطفى ما أهمك” فرأيت السرور يلوح على وجهه، وكان الأمر كذلك، فدمنا على الإحسان والملاطفة مع ابنه، وكان لا يثقل علينا شيء من أحواله التي كانت تثقل على غيرنا، إلى أن توفي رحمة الله عليه، ولم يُخلف إلا بنت فقمنا على مراعاتها أيضاً إلى أن تزوجت، وهي الآن تحت أحد الأتباع إسمه السيد … وفقه الله إلى كمال البرور معها ومراعاة احترامها، ومازلنا نحن في مراعاة الإحسان لها، وفقنا الله وإخواننا لمثل ذلك. أما زوجته فقد تزوجت من بعده، ومع ذلك فإني أجد من نفسي مُراعاتها واحترامها، أصلح الله أمر الجميع. ثم أعود لما كنت بصدده فأقول: بعدما أخذنا وديعة الأستاذ رضوان الله عليه، أخذت الاحبة في تجهيزه، ثم دفن بزاويته بعدما قدمت في ذلك للصلاة عليه، أمطر الله على قبره سحائب الرحمة وجلائل النعم، وبعد تلك المدة بأيام قلائل ورد عليّ خبر من أصهارنا بمدينة تلمسان يقولون فيه أن زوجتكم في أشد مرض، فذهبت إلى تلمسان وعندما وصلت وجدتها على آخر رمق، وكانت متدينة بارة حسنة المعاشرة، وبعدما مكثتُ معها نحو الثلاثة أيام انقضى نحبُها، وانتقلت شهيدة إلى عفو الله. رجعت إلى مستغانم حالة كوني فاقد الأستاذ رضي الله عنه، والزوجة، وما بيدي من الأثاث وأسباب المواد مع فقدان رخصة السفر، لأنه انقضى أجلها. وبعدما ذهبت للحكومة لتجديد الرخصة سوفتني أياماً، ثم وعدتني على أن تكون لي بانفرادي بدون الأهل، وهكذا وعدوني وفي مدة رجاءي لصدورها كان رجال الطريق عندنا تتفاوض فيمن يقوم بشؤون الفقراء، أما أنا فما كنت أحضر إلى مفاوضاتهم، بما أني مستسلم لما يُريدون، تابع لما يُشيرون، وثانياً كنت غير ساكن البال من جهة المكث بهذا الوطن، فقلت لهم : “لكم أن تصدروا من شئتم لهذا الأمر وأنا معاضدكم”، بما أني كنت على علم أن في الجماعة من هو على استعداد، وعندما وقع من الفقراء عند اجتماعهم نوع محاكمة يُشم منها رأئحة التباين، لأن كل واحد يُبدي من نظره بما يراه إصلاحاً، وكل ذلك لعلمهم بعزمي على الإنتقال. فقال المقدم ولي الله سيدي الحاج بن عودة بن سليمان :”فلا بأس لو تركنا الإجتماع للأسبوع الآتي، ولكن من رأى من الفقراء رؤيا فليخبرنا بها”، فاستحسن الجميع هذا الإقتراح، وما تم الأجل المضروب حتى توالت المرائي، وبلغت لعدد وافر، وكلها سُطرت في ذلك الحين، وما من رؤيا إلا وهي صريحة الدلالة في كون الأمر متوجهاً إليّ، فاشتدت عزيمة الفقراء على أن يُلزموني المُقام بين أظهرهم، والإشتغال بوضيفة التذكير، وبما أنهم يعلمون أن النية لا تتحول من جهة السفر، ألزموني أن أقوم بشؤون الفقراء ولو في مدة انتظار الرخصة للسفر، أما نيتهم فكانوا يريدون تحجيري عن السفر بكل وسيلة، وممن كان يشتد حرصه على بقائي بهذا الوطن الصادق العزيز ولي الله: أحمد بن ثريا، رضي الله عنه ورحمه، فقد بذل وسعه في ذلك رغبة منه ومحبة في الله لا غير، ومن جملة صنعه أن زوجني ابنته لا على شرط، مع علمه أني كنت عازماً على الذهاب، فقبلنا ذلك منه بكل سرور، وأصدقناها صداقاً ميسوراً، ومن سوء الحظ أنها لم تتوفق للمعاشرة مع الوالدة، كان ذلك بعدما مضت المدة، فاشتدت حيرتي لما كنت عليه من مراعاة إسعاف الوالدة رحمة الله عليها، وقد كنت ساعفتها على عدة نوازل أشبه شيء بهاته النازلة، غير أنها في هذه المرة كبُر علي ما استصغرته في غيرها من جهة الفراق. أما التوفيق بين الجانبين فقد كان يظهر بعيداً جداً، ولما رآى الصهر المذكور ما آلمني من الحيرة في ذلك الشأن، عرض علي جانب الفراق، وطلبه مني بإلحاح قائلاً : “لا يصلح بك إلا مراعاة حق الوالدة، أما حق الزوجة يصح فيه أن يُقال :(وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته)، وكل ذلك لا يثير أدنى شيء في مودتنا إن شاء الله”. وكنت أعلم الصدق منه، غير أن عواطفي لم تسمح بذلك، ولما قضى الله به عليّ على كره من الفريقين، كان لي نصيب وافر من الأسف، وليس هو بأكثر مما كان للصهر المذكور، ولكن على مراد الله، وكل ذلك لم ينقص من الصداقة بيننا إلى أن لقي الله ذلك الرجل المبرور على أتم مودة فشكراً لعواطفه، ما أجملها في طريق الله! ومما هو أشبه بهذا ما وقع بيني وبين حضرة العارف بالله سيدي (حمادي بن قاري مصطفى)، فقد قضى الله بالفراق مع إحدى الزوجات من عائلته، وكان هو المتولي شؤونها، فإني والله ما رأيته ولا سمعته منه ما يقرب من الصهر الأول، وإن الصداقة دامت بيننا إلى الآن والحمد لله، زاد الله روابط المحبين في الله. أما السبب في هذا الفراق فهو ما خامر العقل في ذلك الحين من الإشتغال بالعلم أولاً، وبالذكر ثانياً، فضاع حق الزوجة فيما بين ذلك، وكاد أن يضيع حق العائلة تماماً، وهكذا قضى الله علينا بمفارقة أربع زوجات، وما كان ذلك مني لسوء المعاشرة، ولذلك لم تعتبره الأصهار مني سيئة، فجميعهم إلى الآن على التعريف السابق، والذي يزيد في الإستغراب، أن بعض الزوجات سمحن في بقايا مهورهن من بعد الفراق. وبالجملة فإن كان هناك شيء من التقصير فأكون أنا به أحرى، ولكن ما تعمدناه. ثم أقول أنه لما انقضى نظر الفقراء أن لا يسمحوا لي بالذهاب، وساعدتهم الأقدار على ذلك، فعزموا على اجتماع عمومي يكون بزاوية الأستاذ رضي الله عنه، ولما وقع الإجتماع تحت أنظار كبار الفقراء، وكان من جملتهم حضرة العارف بالله سيدي (الحاج محمد بن يلّس التلمساني) المهاجر الآن بمدينة دمشق بالشام، فتولى خطاباً يذكر ما يحتاج إليه المقام، ثم وقعت البيعة من جميعهم قولاً، وهكذا استمرت على ذلك من أكابر الفقراء، أما المبتدءون فكانت تؤخذ منهم بعد ذلك بالمصافحة، أما من كان من أتباع الطائفة خارجا عن البلاد، فإني ما كاتبت أحداً منهم، ولا ألزمتهم بالرجوع إلينا، حتى أخذت بعد ذلك تتوارد علينا طوائف الفقراء مختارين معترفين، يشهدون على أنفسهم، ويُخبرون بما سمعوه من الأستاذ، أو حصل لهم من قبيل الإستعداد، وهكذا إلى أن انضم سائر أفراد الطافئة، ولم يبق منها إلا اثنان أو ثلاثة، وكان يعد ذلك الإنضمام من الفقراء كرامة، لأنه لم يكن بيدي من الأسباب والدواعي الخارجية ما يستلزم الإحاطة بافراد مختلفي الفقاع، إلا ما لديهم من اليقين الصرف من جهة ما كنت عليه من المكانة مع الأستاذ في هذا الشأن، وكانت ثابتة الدعائم من جهة معرفة الحق، والإعتراف به كيفما كان، وهكذا كان يمكنهم من ذلك حتى كان فيهم سجية والحمد لله، وبعد ذلك أخذت طوائف الفقراء تتوارد على كما تقدم، فأخذنا بيعتهم وأوصيناهم بما ينفعنا وإياهم، وكنت أنفق على الزوار في ذلك الحين مما كان تحت يدي من الأثمان المستعد به للهجرة، وما كنت آخذ منهم شيئاً، وهكذا كانت نفسي لا تطمأن للأخذ من الناس، فبقيت بعد ذلك متحيراً لم أدر ما العمل، ولا أين توجدمرضات الله، هل في الإنتقال حسب اللزوم، أم في قطع النظر عن ذلك، والإشتغال بتذكير الفقراء حسب المحتم، إلى أن قضى الله بزيارتي لدار الخلافة فألقى في باطني ذات يوم شيء من الإقباض، ودام علي، فأخذت أتسبب فيما ينشرح به صدري، فظهر لي أن أزور بعض الفقراء خارج البلد بنحو أربعين ميلاً، فأخذت بيدي أحد الطلبة كان في ضيافنا يدعى الشيخ (محمد بن قاسم البادسي الفاسي) وسرنا على بركة الله، وعندما وصلنا المحل المقصود ظهر لنا لو أننا زرنا بعض الفقراء بمدينة غليزان فكان ذلك، وبعدنا قضينا في زيارتهم نحو اليومين، قال لي رفيقي :”لو أننا وصلنا لمدينة الجزائر بما أن لي فيها بعض الأحبة، زيادة على ذلك نباشر بعض المطابع فربما يتيسر طبع (المنح القدوسية) على المرشد المعين لأنها كانت بأيدينا في ذلك الوقت، فساعفته على ذلك ولم يكن لنا من الفقراء بالجزائر أحد، وعندما وصلنا اشتغل رفيقي بملاقاة صديقه، غير أنه لم يرق في نظره ذلك الإجتماع، وبتلك المناسبة قال لي :”إن البلاد التي لم يكن فيها الفقراء فهي خالية، بما كان يلقاه مما جبلت عليه الفقراء من الملاطفة وحسن الإقبال، وبعدما باشرنا بعض المطابع ظهر لنا عدم التهيء لذلك الأسباب، فقال لي رفيقي أيضاً :”لو أننا ذهبنا إلى مدينة تونس لكان الأمر فيها متيسراً من كل الوجوه. وكنت أقوم أنا بتصحيح وبمراجعة الطبعة، وبما هو من ذلك القبيل، فساعفته على ذلك وسرنا من بلد إلى بلد إلى أن دخلنا إلى مدينة تونس وما كنت أعرف بها أحداً من الذاكرين إلا رجلا حاملاً لكتاب الله كفيف البصر، يدعى السيد (الحاج العيد) كان يمر علينا بمستغانم إذا جاء زائراً لأستاذه بناحية المغرب، وكنت أعرف أيضاً أحد العلماء الأعيان السيد (صالح الشريف) كنت اجتمعت به في زيارتي الأولى لمدينة تونس بمطبعة أحد الصحفيين، والسيد (الحسن بن عثمان) مدير جريدة الرشدية وكان سبب اجتماعنا تقديم كتاب لنا يُسمى “مفتاح الشُّهود” للطبع، وقد اعتبر حضرة المُشار إليه هذا الكتاب اعتباراً زائداً، أما الشيخ سيدي (صالح) فقد وجدته مهاجراً في ذلك الحين. وأما من كانت تربطنا بهم وصلة الوطن من المهاجرين بمدينة تونس فجماعة كبيرة، وما قصدت الإجماع بأحد منهم، ولهذا دخلنا إلى تونس على حين غفلة، فاكترينا محلاً للنزول فيه، وألزمتُ نفسي على ألا أخرج حتى يأتي إلينا أحد الذاكرين نخرج معه، كان ذلك بسبب رؤيا رأيتها، جاءت أناس من المنتسبين ودخلوا إلى المحل الذين أنا فيه، ثم أخرجوني إلى محلهم، ولما ذكرت ذلك إلى رفيقي كبر ذلك عليه، وقال لي : “أنا ما جئت لأقعد بين الجدران”. فكان يخرج ليقضي لنا بعض الأمور ويجول في بعض المواطن ثم يرجع، وبعدما قضينا في ذلك المنزل أربعة أيام دخلت علينا تلك الجماعة التي رأيتها في المنام، وإذا هم أفراد من أتباع الشيخ سيدي (الصادق الصحراوي) رضي الله عنه، وقد كان توفي قبل ذلك بأشهر، ونسب هذا الشيخ في طريق الله يتصل بالشيخ سيدي (محمد ظافر) عن أبيه سيدي (محمد المدني) وهو عن الشيخ سيدي (مولاي العربي الدرقاوي) رضي الله عن جميعهم. وبعدما استقر الجلوس بتلك الجماعة وتحدثنا مليّاً، وكنت أرى لوائح المحبة تظهر عن سيماهم، وقد طلبوا مني الحروج معهم والذهاب إلى حيث يشاءون، ولم يتركوا جهداً حتى أخرجوني معهم، وأنزلوني بمحل أحد الأصدقاء، وهكذا كنت عندهم مكرماً معززاً، وبالجملة فإني ما رأيت من تلك الجماعة إلا الجميل، جزاهم الله خيراً، وكنت مدة مُكثي بتونس تتوارد علي أفراد الفقهاء والفضلاء، وكانت تحصل مذاكرات ومفاهمات في عدة نوازل، ومن جملة من عقلت من أسماء الفقهاء الذين اجتمعت بهم حضرة المحدث الشيخ سيدي (الأخضر بن الحسين) وحضرة الشيخ سيدي (صالح القصيبي) والمدرس الشيخ السيد (احسونة الجزائري) وهكذا عدة طلبة منهم مطوعون ومنهم دون ذلك، وقد دخل الطريقة جماعة من القسم الأخير، وقد كان اقترح علي بعض الطلبة أن أجعل لهم درساً في “المرشد المعين” وأبسط لهم كلاماً فيه من طريق الإشارة، فكان ذلك في قول المصنف :
وجوده له دليل قاطع * حادة كل محدث للصانع
فوقع ذلك موقعاً حسناً عند السامعين، وكان هو السبب في تعلق بعض الطلبة بالطريق، وهكذا قضينا تلك المدة بين الذكر والتذكير، وقد انتفع البعض فالحمد لله بتلك الزيارة.
أما مسألة طبع “المنح القدسية” فقد كنا تعاقدنا مع صاحب مطبعة السيد (البشير الفورتي) بواسطة رفيق كان يُدعى الشيخ سيدي (محمد الجعابي) وقد كنا نجتمع بهما على أحسن وداد وأتم ملاطفة، وهذا هو الحامل لنا على عقدنا مع تلك المطبعة، مع علمنا أنها كانت في ذلك الحين ضعيفة المواد، وبتلك المناسبة لم يقع تنجيز الكتاب في الوقت المتفق عليه، فألجأتني الضرورة إلى أن أتركه لمن يقوم به ونذهب، وعندئذ قصدت مدينة طرابلس الغرب، لزيارة أبناء عمنا كانوا مهاجرين بها، وكانت سببا في اللحوق بهم حسبما تقدم، فظهر لي أن أغتنم الفرصة في الحلول بذلك القطر، حيث أن رخصة السفر كانت بيدي، وقد تحركت في ذلك الحين داعية الزيارة لبيت الله الحرام وللقبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ومن سوء الحظ ورد عليّ كتاب من مستغانم في ذلك الحين يخبر أن الحج ممتنع، ويحذرني من الوقوف في تلك السنة بما يعود علي من العقوبة، وعلى كل حال ركبت الباخرة منفرداً إلى مدينة طرابلس، وكان الفصل فصل شتاء بارد، وقد لحقتني بسبب سفري فيه متاعب، وما انشرح صدري إلا يوماً واحداً كنت أتفكر في قوة ذلك الخلق الذين غصت بهم الباخرة من الحربيين وغيرهم، وقلت :”هل يوجد بين هؤلاء رجل ذاكر؟” فلم تمر علي مدة حتى وقف على رأسي أحد المسافرين، وأخذ يحدق بنظره إلي ويتفرس، ثم قال لي :”أليس أنت الشيخ سيدي أحمد بن عليوة؟”، فقلت له :”من أنبأك؟” فقال :”كنت أسمع بك، ومنذ حين وأنا أتفرس فيك، وقد ظهر لي الآن أنك أنت ذلك الرجل”، فقلت له :”نعم”، ثم انفصلت من ذلك المحل إلى محل آخر وسألته عن إسمه فقال (الحاج معتوق) وعندما أخذنا في الحديث وجدته من العارفين بالله، فقلت له :”هل لك مؤازر في بلدك؟” فقال لي :”أنا من مدينة جربة منفرد بهذا الفن” فمرت تلك المسافة على أحسن ما ينبغي إلى أن نزل في مدينة جربة ونزل من معه، فعدت لما كنت عليه من الإنقباض على ما يقتضيه الإنفراد وسفر الشتاء، إلى أن نزلت بمدينة طرابلس فوجدت أبناء العم في انتظاري بالميناء، وكان كل منا يترقب وقوع بصره على أخيه لما لحق الجميع من الأسباب التي قضت بتفريق الشمل، وعندما دخلنا المنزل واستقر بنا الجلوس، وتفاوضنا في شؤون الهجرة وما هو من ذلك القبيل، فأخبروني أنهم في أمان الله من جهة شؤونهم المادية، أما البلاد فقد ظهر في ذلك الحين أنها صالحة للإنتقال، بما أن أهلها أشبه حال بأبناء وطننا لغة وأخلاقاً، وقد كنت سألت في ذلك الحين وأنا بالمنزل عند المغرب أبناء العم : هل يعرفون هناك أحداّ من الذاكرين أو من المشايخ العارفين؟ فقيل أنهم لا يعرفون إلا واحدا من المشايخ الأتراك كان يُدعى (الشيخ أحمد) وهو رئيس في إحدى الدوائر الرسمية ويتوسمون فيه رائحة الصلاح، فقلت لهم :”هل يمكن الإجتماع به في الغد؟”، فبينما نحن في ذلك الحديث وإذا بطارق يطرق الباب فخرج أحد ثم رجع قائلاً :”هاهو الشيخ واقف عند الباب يستأذن الدخول عندكم” وما كان قبلُ يأتيهم إلى محل سُكناهم، فقلت لهم :”أدخلوه”، وإذا هو رجل طويل القامة طويل اللحية متزي بزي الاتراك لباساً وهيئةً. فقال :”السلام عليكم”، فقلنا “وعليكم السلام ورحمة الله”. وعندما أخذ مجلسه قال :”إن أحد المغاربة يقول في تجلي الإله ويعني به الششتوري بقوله :
محبوبي قد عم الوجود * وقد ظهر في بيض وسود فقلت له :”دع كلام المغاربة للمغاربة وايتنا بكلام المشارقة”. فقال :”إن القائل قال (عمّ الوجود) فلم يخص غرباً ولا شرقاً”. فعلمت إذ ذاك أن الرجل مستغرق في الفن المُشار إليه، فقعد معنا سُويعات في تلك الليلة والرغبة آخذة بمجامعه، فرأيته ينصت بكل جوارحه، ثم استأذننا في الذهاب على شرط أن نزوره غداً في بمحل عمله الرسمي، ومن الغد واصلناه إلى محله، أعني إدارة الواردات البحرية، لأنه كان رئيساً بتلك الإدارة، فتلقانا بمزيد السرور وأمر بتعطيل الأشغال وتسريح الكتاب، مع أنها كانت أشغالاً جمةً. ثم انفردنا ناحية وجالت بيننا عدة مُذاكرات في شؤون من علم القوم يطول ذكرها، ومما يحسن ذكره أنه قال لي :”إن شئت المُكث ببلادنا فهاهي الزاوية عليك حبس، وما حاذاها من الحوانيت، وأنا أكون خادماً لحضرتكم”. وقد كنت أعلم الصدق من جميع مقاله، فوعدته على أن أنتقل إلى هناك، وتجولت في البلد ساعة فوجدت في نفسي ميلاً لذلك الوسط كأنه طبيعي، وفي ذلك اليوم اجتمعت ببعض المهاجرين من أهل تلمسان كانوا نازلين هناك، وقد فقدوا ما بأيديهم، كما كانوا فاقدين المعين أيضاً، وقد حصل لهم من الأنس عند الإجتماع بنا ما أنساهم الشدة التي كانوا فيها، وقد كنا لهم سبباً في محل المبيت وفيما يخصهم في تلك المدة. وفي اليوم الثالث سمعت منادياً ينادي لمن يريد الرحيل إلى الأستانة ويذكر أن الباخرة تلركب إليها بقيمة زهيدة، وأنه يذهب قبالة. فتشوقت لزيارة دار الخلافة، وظهر لي ما ربما أن أدرك من العلم ما أنا إليه في احتياج، فطلبت أحداً من أبناء عمي أن يذهب معي فوعدني بالذهاب غير أنه امتنع من الركوب لما رآه من هيجان البحر وتلاطم أمواجه، لأنه كان على حال لا يتأتى فيه السفر وكفى أنه فعل …
ولا تسأل عن ركوبنا وكيف كان حاله، ولما استقررت على ظهر الباخرة أخذت أتخيل وأتذكر بم نا مستعين على هذا السفر؟ فوجدت لا شيء أتأنس به غير الإعتماد على الله.
دخلت الأستانة بعدما كابدت من ألم هيجان البحر ما كان يقضي على حياتي، والذي زادني أسفاً أنني لم أجد بالأستانة في ذلك الحين ولا أنيساً يأخذ بيدي، ولقد اضطررت حتى لعبارة التحية لما كنت أجهله من اللغات التركية، وفي ذات يوم كنت أجول طرف البلدة، وإذا برجل صافحني وحياني بلسان عربي مبين، فسألني عن إسمي وعن بلدي فنسبت له، وإذا به هو أحد الفقهاء الجزائريين يتصل نسبه بالنسب الشريف، وكنت يومئذ حريضاً على الزيارة لدار الخلافة فاستعنت به، فكان خير مُعين على الغرض المذكور، غير أني لم أشف غليلي منها لتكوين الحواديث الخلافية التي كانت على وشك الإندلاع، فيما بين الأمة التركية وشبابها الناهض، أو المصلح كما يقولون، وكان من رؤساء هذه الحركة أفراد معدودون أبعدتهم الحكومة عن سُلطانها، فانتشروا في بلاد أوربا وأسسوا الجرائد والمجلات، وتجردوا لانتقاد الحكومة وكشف عوراتها من بين الدول الأجنبية، فوجد المغرضون بتلك الحركة العوجاء نوافذ وأبواباً فتسربوا منها إلى قضاء حاجتهم، فكان من قضاء الله على دار الخلافة أن وقع القبض على مالكها وزج به في السجن، وتمادى الشباب الناهض على عمله دون شعور ولا مبالاة إلى أن بلغوا بغيتهم آخرا، واتضح الصبح لذي عينين من عنوان النهوض والوطنية والإصلاح، ولا أزيدك بسطة، وفي حركة الكماليين ما يُغنينا عن تتبع النوازل فقرة فقرة.
تيقنت أن ما أريده من المُقام بتلك الديار غير متيسر، لأسباب أهمها ما تفرسته من انقلاب المملكة إلى الجمهورية، ومن الجمهورية إلى الإباحية، فقفلت راجعا إلى الجزائر مكتفياً من الغنيمة بالإياب، وفعلاً لم يرتح بالي ولم يسكن روعي إلا في اليوم الذي وطئت فيه تراب الجزائر، وحمدت الله على ما كنت أستحسنه بالطبع من عوائد أُمتي، وجمودهم على عقيدة آباءهم وأجدادهم، وتشبثهم بأذيال الصالحين.
انتهى ما وجدته مكتوباً بعبارته، وتتميماً للفائدة نذيله بما في علمنا من يوم قُدومه إلى اليوم الذي ختمت فيه أنفاسه الطاهرة.
رجع رضي الله عنه من جولته تلك وكتابه القديم المسمى “المنح القدوسية” قد تم طبعه، وانتشر ذكره عند كثير من الناس.
أما الأستاذ فمنذ أن استقر به النوى، لم يزل معتكفاًُ على تدريس الفقه والعربية، وبث الهداية الإسلامية من بين أبناء الملة ورجالها المؤمنين، وعلى إثر هذا العمل انتشرت نسبته في عدة بلدان، خصوصاً في البوادي حول مدينة غليزان، ومدينة تلمسان، وقد بلغ أمره فيها أن صارت أتباعه تُعد بالمئات، وقد شهد له فيها بكرامات عديدة، وفيوضات ربانية، حتى كان في مجلسه من يصعق من خشية الله، وفيه من يفتح عليه بمجرد نظرة أو عطفة من عطفاته، وإن كثيراً ما بديوانه من القصائد كان منشؤه بمدينة تلمسان، وكانت أهل تلمسان تُجله كل الإجلال، سواء في ذلك مشايخها وفقهاؤها وذوو الفضل من تجارها، الأمر الذي لم يكن لغيره من معاصريه.
وفي تلك الأيام أيضاً ألف كتابه المسمى ب”لباب العلم في تفسير سورة والنجم” فجاء من أكمل ما ينتفع به المنتسب، ويرغب فيه الراغب من مرضاة الله، وقد كثر تردده في ذلك التاريخ على مدينة تلمسان حتى كان يزورها المرتين والثلاث في السنة، ويكاد يستغرق في كل زيارة ما يقرب من نحو الشهر أو الشهرين بتمامها، وإن اليوم الذي كان ينزل فيه بين أهلها يكون يوماً مشهوداً من بين الناس، بحيث كانت تغص فيه محطة القطار بالمنتظرين، وكان يُقابل فيها بكل حفاوة وإكرام.